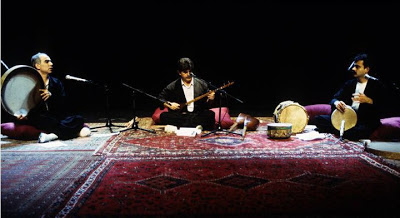سليمان القانوني وما أدراك ما سليمان! أكاذيب وحقائق وقصص كثيرة دارت حول هذا السلطان تحديداً، وخاصة بعد المسلسل المسمى بحريم السلطان.. طبعاً لم أذهب لاسطنبول للتحقق في تاريخ أحد، لكن كان من المهم أن أزور جامع السليمانية أحد أجمل العمارة الخالدة في اسطنبول.. سأعترف بشيء ما هنا، وهو أني كلما استرجعت الحضارة العثمانية ومنجزاتها شعرت بشعور غريب، مشاعر مختلطة وأحياناً متضاربة على الرغم من أن مشاعر حبي لها تغلب المشاعر الأخرى على الأرجح، لكن حين أمرر فكرة الحضارة وفكرة الإنسان وسطوته وإرادته دائماً في بسط نفوذه اتحيز للفرد واحتياجاته فأشعر دائماً بشيء كالحزن، فامتداد الدولة العثمانية كل ذلك الامتداد يجعلني أتخيل أنها لابد وأنها مارست بعض الاستبداد الذي ساعدها لفرض ذلك النفوذ. وإلا كيف أفسر قوتها ومن ثم ضعفها وانتهاءها بعقلي البسيط وعلمي القليل؟ دعوكم من هواجسي ودعونا نتتأمل في نوعية الحضارة التي خلفّها العثمانين في اسطنبول لتهدأ النفس.
خرجنا من الفندق متجهين لجامع السليمانية لكن هذه المرة بالتاكسي، أخبرنا العم العجوز عن وجهتنا فأشار لنا بأن الجامع قريب جداً لكنه لم يمانع في نقلنا، أخذ يحكي لنا خلال الطريق عن الجامع بلغته التركية بسعادة غامرة وفخر، لم نفهم كامل حديثه لكن بضع كلمات عربية أسعفتنا لفهم سياق جمله وتراكيب حديثه، إلى جانب المعلومات التي كنا نعرفها مسبقاً عن السلطان وجامعه، فكان يقول العم العجوز صاحب التاكسي بأن الجامع قد بناه المعماري سنان باشا وهو أحد أهم المهندسين في تاريخ الدولة العثمانية وهو ذاته الذي بنى في الحقيقة أغلب المساجد والقصور وأعظمها، ثم حاول أن يشرح لنا بأنه عند دخولنا سنجد مقبرة كما اسمها “تربة” تلك التي يوجد فيها ضريح السلطان سليمان القانوني.
وصلنا جامع السلطان سليمان القانوني.. ويالذهول فقد كان حقاً تحفة معمارية، وجوهرة هندسية باذخة في الجمال.. كانت تتوسط سقف الجامع قبة كبيرة ضخمة تداخلت معها قبب صغيرة أعطت الجامع منظراً مهيباً جمالياً يسطو عليك، ابتدأنا الزيارة من حيث المقبرة والضريح وماحوله، مشينا قليلاً في فناء المسجد، أخذت أتأمل المكان والبناء لوقت طويل، وفي تلك الأثناء دخلنا الساحة الداخلية وعندها أخذت أراقب المدخل المؤدي لرقعة العبادة والصلاة، حيث كانت تقف عندها مجموعة من السياح الأجانب. بدأ نساء تلك المجموعة بغطاء شعرهن بقطعة من القماش، أما الرجال فقطعة القماش تلك تعطى لأصحاب الساق المكشوفة لسترها. عند تلك البوابة يبدأ كل زوار المسجد بخلع أحذيتهم ووضعها في كيس مخصص أياكان غرض زيارتهم، ثم يدخل المسلمين وغيرالمسلمين من باب واحد لا من أبواب متفرقة. يقف غير المسلمين في مساحة معينة داخل المصلى لمشاهدة الصلاة والتصوير، وفي بعض الأحيان يرافقهم مرشد يسرد عليهم تقسيمات المسجد وأسباب بنائه بهذه الطريقة من الداخل خاصة فيما يتعلق بالمحراب وغيره. في الحقيقة يتذمر البعض من فكرة غطاء الشعر وأجزاء من الجسد، إلا أن أكثر الذين تذمروا أمامي في النهاية تقبلوا الأمر.
الفناءات والمباني الموجودة حول الجامع تستطيع أن تصور لنا سبب تسميته ب”جامع” السليمانية، فكما قال التاريخ أنه كان جامعاً حقيقياً فيما مضى فهو لم يقتصر ليكون مكاناً للعبادة فقط بل كان مدرسة ومكتبة، كان للحياة الروحية والفكرية والاجتماعية و حتى الإبداعية. لا أقول للحياة لأنه ذات مهام متعددة فقط بل لأنه حمل رمزية القوة الفنية للعمارة العثمانية التي تتلخص في الجمال والإبتكار قبل كل شيء، فأستطيع الآن استحضار فكرة الحبر التي ابتكرها سنان باشا خلال تصميمه لهذا البناء، فيقال أن سنان بنى غرفة تجمع الدخان الأسود المتصاعد من قناديل المسجد بطريقة ما ليصنع من هذا الدخان حبراً للكتابة، لم أشاهد هذا بعيني لكن الفكرة وحدها أذهلتني. ليس هذا فحسب بل نرى معنى الحياة من خلال طريقة البناء الفريدة للجامع، فكما أرى فإن الحضارة العثمانية قد اعتنت حقا بالجمال على إطلاقه، فلا أستطيع نسيان ساحات الجامع وأعمدته الرخامية العتيقة إلى جانب النقوش والزخارف الصغيرة والكبيرة على المآذن والقباب التي تراكمت جمالاً على جمال، كل تلك التفاصيل الملونة المزخرفة على القبة الضخمة في الداخل تثير مشاعر روحانية وجمالية عجيبة، تعير قلبك وجوارحك سمة النطق الغير منطوق خاصة خلال تجولك في أنحاء المسجد من الداخل، فأنا قد اتسعت عيني دهشة لتلك الرسومات والصبغات والألوان التي كانت كحِليّة اكتست بها نوافذ الجامع. ولا أنسى تفاصيل خط الثلث التي كتبت به بعض من آيات القرآن.
خذ مني هذا الوعد، حين ترى تلك الآيات على تلك القبة الكبيرة ستظل تتأملها بإعجاب ورأسك وعينيك مرفوعة لأعلى لفترة ولا شيء سينبهك بالوقت سوى الألم الذي سيتسلل لرقبتك دونما شعور!!
لن أسهب كثيراً في الوصف أو بعبارة أصدق لم أعد أملك من اللغة ما استطيع به الوصف أكثر، لكن أبنية وعمارة كهذه تحمل هوية عثمانية يستطيع الكل اليوم تمييزها، بالرغم من أن سنان باشا كما قيل قد استقى بعض الأفكار الهندسية لهذا الجامع من العمارة البيزنطية التي تمثلت في آيا صوفيا إلا أنه أخرج الجامع بهوية و طراز عثماني. وكأنه كتب عليه بخط عريض صنع في اسطنبول.
صلينا فيه ومن ثم خرجنا من أحد باحاته الكبيرة، فوجدنا أكشاك تبيع بعض التذكارات، وغالباً ما أحب أن اشتري من أماكن كهذه لأن النظر إلى تلك التذكارات بعد مدة يجدد ذاكرتي ويبقي على التفاصيل واضحة أمام عيني.