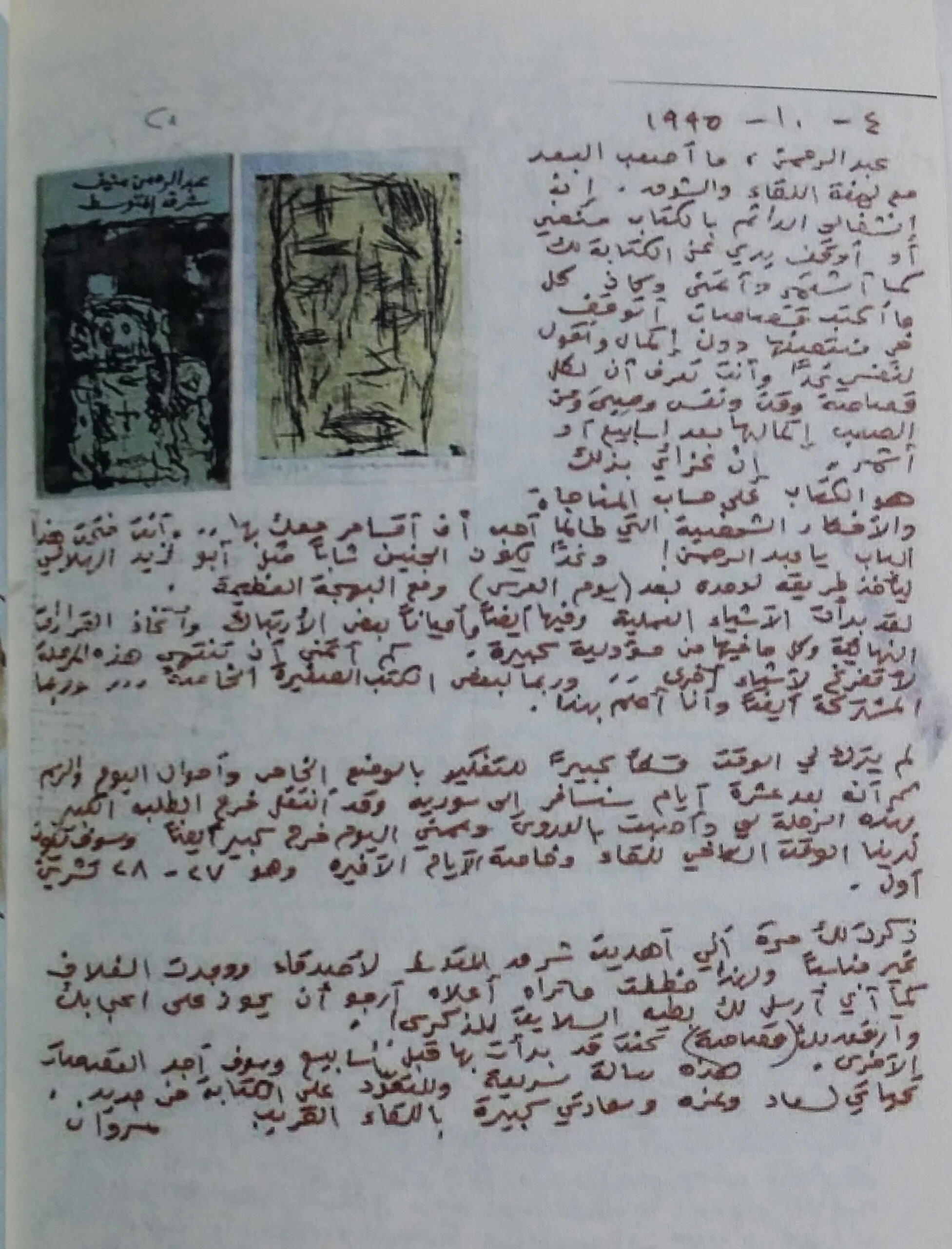تجربة في موقف !
لا أحب تصنيف التجارب، ولا الحكم عليها، لأن كل ما أعرفه خلال نفسي هو أن التجربة ماهي إلا حكاية خاصة جداً، تخصك وحدك، بمعنى أني لا أصدق بيقين تام أن التجارب هي تلك فقط التي تنحاز للمخاطرة بتسلق جبل ما، أو النوم في الصحراء .. التجربة بالنسبة لي، هي تلك التي تحرك فيّ شيئًا، تثريني وتنمي تحت جلدي شيئًا يخصني، فأتحول في هذا الجزء والتفصيل الصغير من كائن تنظيري لكائن تجريبي وأفهم المسألة ليس بعقلي المجرد، إنما بروحي وكياني كاملاً، وهنا أنا لا أبالغ، ربما أكون حساسة تجاه الكثير من الأشياء بشكل مبالغ، لكن هذا أمر حقيقي فعلاً، حتى في أتفه الأمور، فمثلاً لطالما كان المشي، المشي الطويل جدًا والإصغاء لكل شيء أمر به من خلال عيني، وقلبي، وروحي، وأذنيّ، ويدي، وأفكاري التي تتكاثر وتتبلور، هي تجربة. ربما ستسخر مني وأنا أتحدث بهذه اللهجة التي تبسط المعنى. لكن هذا شيء تلمسته خلال هذه الفترة من حياتي .. أمشي مسافات شاسعة باستمرار، ولا أعتبر هذا المشي، هو الانتقال من نقطة لأخرى، بل هو عملية للتأمل، وللمراقبة، والانتباه، وربما حسب ماشعرت فقد تلمست شيئًا شبيهًا لما أتحدث عنه. ذات مرة قطعت أكثر من 20 كيلو متر في نواحي اسطنبول خلال نهار واحد، صافح قلبي خلالها أزقتها الصغيرة، تلفّتُ لما كتب على جدرانها القديمة، تركت لعيني بأن تعبر عيون المارة وتلحظ أرواحهم. وأنا أمشي، قررت بشكل مفاجئ الدخول ل أحد المحلات للبحث عن أسوارة لابنة أختي، قلبت كل القطع قطعة قطعة، كنت أحاول أن أجد شيئًا يشبهها تمامًا، شيء يبهجها عميقًا، خلال انشغالي بالبحث عن هذه القطعة الفريدة ، حدثني صاحب المحل قائلاً: تبدين من اندونيسيا ، فلك ملامح تشبههم. التفت إليه وقد ظهرت على وجهي علامة تعجب كبيرة وصمت غريب، ربما لأني لم أظن يومًا بأن أحد غريب، في شوارع مدينة غريبة، يلمح هذا الدم القديم في وجهي، أظن بأني تلفتُ حولي لأتأكد أن الحديث موجه لي، بحثت في أرجاء محله الصغير عن مرآة لأنظر لنفسي، وكأني أريد أن أتأكد بأن ملامحي تلك قد انحفرت أكثر مع الزمن، لكني اختصرت الأمر وهززت رأسي موافقة على كلامه، لكن عيناي ظلتا تتسع من المفاجأة، نظرت فيه، ابتسمت، وشكرته وخرجت، فأنا لا أطيل الأحاديث مع أحد أبدًا، أطويها واختصرها قدر الإمكان، وهذا دعونا نقول بأنه ليس بالأمر الجيد، لكن اعتدته مع الوقت، وربما أدمنته، وقد صار يميزني عند البعض، ويبغضه آخرون، على أي حال، أكملت طريقي الطويل بعدها دون وجهة محددة، وخلال عبوري أحد الشوارع، استوقفتني بائعة أزهار متجولة تقف على الرصيف المقابل، نظرت إليّ مبتسمة، و حال ما حطت قدمي على الرصيف الذي تقف فيه مدت لي يدها بمجموعة من الأزهار، طلبت مني بلغتها البسيطة بأن اشتريها، حاولت أن أجد عذراً مقنعًا بأني لا أحتاج أن أقطع المدينة خلال عودتي وأنا أحمل أزهارا في يدي، إلا أنها في أثناء ذلك، باغتتني بسؤالها: من أين أنتِ؟ ولا أخفي عنكم أن هذا السؤال كان قبل تلك اللحظة مزعج بشكل ما، مؤذي أحيانًا، وعنصري دائمًا، ابتسمت لها ابتسامة لا أعرف كهنها لكنها الأنسب في حين أني لا أحبذ أن أجيب عن هذا السؤال إلا في مواطن محدودة ورسمية. تركت لها التخمين الذي يعجبها، و في اللحظة التي حدثت نفسي فيها، بأن أدفع حق الأزهار، وأعيد إهدائها إليها، ادهشتني قائلة: سودانية، أو ربما صومالية؟! فابتسمت ابتسامة تكاد تشق وجهي من اتساعها، ولا أخفيكم أنه أعجبني هذا التصنيف غير المحدود لملامحي -فقد كنت قبل ساعة من ذلك اندونيسية- ولطريقتي، فاكتشفت أن دمي كثيف وأنا كثيرة وأشبه كل أحد ممكن .. ثم أن جغرافية قلبي – كما تبدو هنا- هي أوسع من أن تقتصر على جنسية واحدة أو عرق واحد كما ولّفتها منذ زمن بعيد.. عندها شعرت بأني اكتسبت موقفًا تحول داخلي إلى تجربة أصنفها بأنها روحية، لأنها ظلت ترافق ذاكرتي في كل مرة أتعرض بشكل اجباري لهذا السؤال من عابر فابتسم بقلبي ممتنة لخليط ملامحي ودمي وسمرتي قبل كل شيء.
محاولة استقلال، ربما
أعتدت منذ سنوات على السفر إلى اسطنبول لعدة أشهر، وغالبًا ما كانت بصحبة أهلي إلا القليل، أما هذه السنة، فقد كانت مختلفة كل الاختلاف، لقد عشت غالبيتها دونهم، بدأت الرحلة تقريبًا نهاية فبراير، لم تكن خطة سلسة على أي حال، لكنها بُنيت بشكل منطقي جدًا، وظروف كثيرة ساعدت ليحدث ما حدث، هي بشكل أو بآخر قرار كنت قد اتخذته من قرارة نفسي، فنحن في فترة ما نحتاج لأن نكون على مسافة من كل من نعرفهم طوال حياتنا، نحاول في هذه المرحلة أن نستكشف أنفسنا وكل روابطنا الظاهرة والخفية تجاه تصرفاتنا ومانحب ومانكره في الحياة..
قضيت 300 يوم تقريبًا بصحبة نفسي، ومن الصعب أن أحكي عن المقدرة للوصول إلى صحبة النفس لأن حديثها طويل، ولا يبدو لي أني سأتحدث هنا عن كل شي مررت فيه، فأنت حين تمضي إلى نفسك، لن يكون طريقك أخضر، وهذا تحديدًا ما لن أفصح عنه، أو أحكيه إلّا حين أكون قادرة تمامًا لخوض هذا الحديث المطوّل. لنعود لصحبة النفس، فقد غادرت موطن طفولتي، من أحبهم، حاولت فصل شعوري وروابطي بجميع الناس، رأيت كل مساوئي جلية أمامي، بصعوبة خلعت عني ماليس مني، لأجردني من كل ما ألقته الأيام على كاهلي، من تلك الأوجاع التي لم أوافق لأن تنزرع تحت جلدي، كان لازمًا علي فعل ذلك لأرى تفاصيل روحي وأتعامل مع شؤوني الداخلية بشيء من الصدق والتجرد..
غادرت كل أحد وحاولت أن أجدني في هذا الطريق الطويل .. وتأكدت إننا في الحقيقة لن نعرف أنفسنا بشكل كامل مطلقًا، والإيمان بذلك في رأيي مطمئن لحد ما، للحد الذي يجعلنا لا نتفاجأ بأنفسنا بشكل جارح حين يظهر لنا ماخفيّ عنا منا ذات يوم، نحن في النهاية نتغير باستمرار.. واستمرارية هذا التغير دعنا نقول بأنها، تنجينا .. واخترت النجاة كمحاولة مني لأن أهدئ من هلعي أمام نفسي.. وأنا أكتب، صدقوني، يأتيني صوت بعيد، من خلف رأسي ليسألني: متأكدة؟ هل أنت تتغيرين؟ حقيقة لا أعرف، لكن المواقف ستهدينا الجواب، فنحن تغذينا الظروف، ويتسرب إلينا ما نحاول دائمًا الهروب منه، ويلتصق بنا ما نظن أننا قاومناه، وتجاوزناه ، لكنه يظل يظهر كالظل عند انتصاف شمسنا، ونهارنا، فننكسر ونتأوه .. ولا نعود نعرف التعامل بالشكل المناسب، ولهذا دعنا نسمي التغير المستمر ب عملية “الوعي”، والوعي هنا، يكون بمحاولتنا المستمرة في معرفة لماذا، تصرفنا بهذا الشكل؟ فتبدأ الرحلة، ويبدأ البحث عن أصل الفعل، وتداعياته علينا، وعلى مواقفنا، وعلى الأشياء والأشخاص الذين تورطوا معنا في ذلك الموقف! في الحقيقة، نحن نتنازع بين عقلنا الباطن، وبين مانحاول إصلاحه باستمرار، والخطأ من الجميع وارد، لكن الاعتذار عن الخطأ، وتحمل مسؤولية الخطأ والاعتراف به، هو الفارق بين الناس، وأظن بأني شخص يحاول دائمًا أن يحمل أوزاره على كتفيه، ويعتذر ويأسف عن أفعال لم يتقصدها، فلنحاول بأن لا نجعل وعينا يكون علينا وضدنا ، بل يكن معنا وإلى جانبنا .. وهذا ما أرجوه من نفسي، لنفسي ..
هناك تجارب، ليست من جنس “الصح أو الخطا” إنما هي تجارب، وتجارب فقط، هي التي تجعلنا نفهم النجاح والفشل، تعلمنا التمسك والتخلي، وتشرح لنا أسباب البقاء أو الهروب، تصيغ الحب في قلوبنا وتشكّله، تربكنا بفكرة المسافات والتواجد والحضور والتلاشي .. من خلال قراءتنا لها، قد ننقذ أنفسنا أوقد نهوي، لكنها دليلنا في ليالينا حالكة السواد .. دليلنا، لأيام أكثر تسامحًا مع أنفسنا على الأقل، وأكثر هدوءً ..
أصدقائي في العزلة، كتبي، والغروب، والبحر
أعيش في جنوب غرب إسطنبول، وأعتبر أن هذا الجزء من اسطنبول يشبه الهدوء النسبي، على الرغم من أن المنطقة مكتظة بطبيعة حال أي مدينة ضخمة، إلا أن وجهتي لساحل بحر مرمرة وجلوسي على الرصيف، ومراقبة الصيادين إلى ان يحين الغروب، وتأمل مساحات البحر الشاسعة، واستقبال أمواجه، وهواءه كان قد شكل بيني وبين المكان علاقة مترابطة ووديعة، فصار مناسبًا لمراقبة الشمس بشكل يومي .. وأحاديث داخلية طويلة وذكريات كثيرة، واشتياق لا يبرح قلبي وروحي، تنتهي جميعها بموجة كأنها تلقي بنفسها على قلبي فأشعر بها كتربيتة حنونة من الكون.. إنني في حالة من الجوع لمرحلة سكون عميقة، على الرغم من متطلبات الحياة السريعة ورغبة الإنجاز المجنونة، وتحقيق كل شيء في وقت قياسي، كنت أرغب بشدة أن أكف عن السرعة بكل أشكالها، كنت أجبر نفسي على البطء، وأتعلم كيف ألتقط أنفاسي، وأخرج كل مايفسد روحي مع كل موجة تقترب مني .. ولقد علمني البحر بأنه لطالما تأخذ أمواجه السفن والقوارب وحتى رسائلنا وأصواتنا من موجة لأخرى وترتحل .. وكنت أتعامل بذات الطريقة، فأحمّلها كل أسراري وأرجوها بأن تقف على شاطئ يأبه التقاط سرّي لمن يكترث ..
لست من النوع الذي يجلب معه كرسيا ليجلس أمام البحر، أنا أجلس على الرصيف، أقرأ كتبي وأُنزل قدمي على وجه البحر واستقبل الهواء كصديق عزيز، ما أن يلامس وجهي وجسدي حتى أشعر بشي من الراحة .. فأقرأ له بصوت عال جملة او اثنتين .. فأتخيل بأني أواسيه بعد أن دس أحدهم فيه دمعه قبل مروره أمامي .. لطالما تساءلت عن الشمس والسحب والبحر وتفاصيل السماء خلال تأملاتي.. تساءلت عن هذه العناصر التي تجعل من الغروب اليومي تجربة متفردة كل مرة، عن الألوان التي تتكاثف طبقاتها وفقا لدرجات الحرارة والبرودة كما أظن، فالسماء تكون أجمل ماتكون وهي تودع الشمس والضياء لتستقبل القمر والعتمة .. إنها تعلمنا أدب الغياب، أدب الوداع ربما ..
اسطنبولية أكثر مما كنت أتخيل ..
كنت أظن بأن حياة المدن لا تناسبني، ولهذا كرهت جدة طوال عمري، وحلمت دائما بمنزل ريفي في قمة جبل في منطقة جميلة وساكنة ، حتى اللحظة التي عشت فيها في إسطنبول المدينة الضخمة، مترامية الأطراف، لأكتشف أن الأمر ليس كما أظن، فأنا أجد إسطنبول بكل مساوئها أحب إليّ من جدة.. ثم عرفت بشكل أكثر وضوحا بأن ما أكرهه في جدة بشكل خاصة هو رتم الحياة وطبيعتها (وهنا يطول الكلام لكن لن أتحدث عنه الآن، ربما في وقت لاحق) أما في اسطنبول فلايعوقني شيء، اعتدت على المشي السهل في الحي، واستخدام المواصلات العامة. أخرج من باب البيت فأمشي دقيقتين لأصل لمحطة الباص الأولى، يأخذ مني الطريق قرابة ٢٠ دقيقة لأصل بعدها لمحطة الباص الذي يمر كشريان على امتداد الجزء الجنوبي ثم يتجه للوسط ويتعدى الجهة الاوروبية للاسيوية في غضون ساعتين على الأكثر وأكون بذلك قد وصلت لآخر محطة على هذا الخط.. وهذا الأمر يريحني لأنه لا يقيد حركتي مهما أخذ من وقتي.. ففالنهاية غالبا ما أستغل تلك الأوقات في القراءة، وتأمل الطريق والناس، وهنا سأتوقف قليلا وأتحدث عن شيء غريب حصل معي، فطوال حياتي كنت كثيراً ما أتمزق من شعور الغربة على الرغم من أني أعيش وسط أشخاص لايختلفون عني بشكل جذري على الأقل درسنا في نفس المدارس، تعلمنا بشكل متشابه، نتحدث نفس اللغة، ولطالما استنكرت ذلك الشعور، بل كان شعور الغرابة يصيبني بمرارة عجيبة، بخلاف هذه الأيام في اسطنبول، فأنا متكيفة تماما وأنا أستقل عربة الباص دون اكتراث لأي أحاديث جانبية، أو حتى لما لا أفهمه من كلام، ربما الأمر له علاقة بالمقارنة وأنا لا أجد شيئا أقارن به نفسي مع كل هذا الجمع الغفير من الناس، فنحن نختلف كثيرًا، رغم التشابه، فربما الغربة الحقيقة التي لطالما شعرت بها، هي غربة اجتماعية. وهنا منفصلة عن المجتمع، لأن مجتمعي هو أنا، وعملي، وقلبي، وأفكاري، وكل ما أحاول القبض عليه ليقربني إليّ، فقد اخترت وحدتي فوق كل شيء، وهذا يؤكد على أن متطلبات الحياة الاجتماعية في جدة لاتناسبني وكلما خالطت وانغرست في المجتمع الذي يقدم لي قائمة من الطلبات لألتزم بها، يجعلني أصطدم بدواخلي أكثر فأنزع لا إراديا لإحساس الغربة ..
اسطنبول منحتني سهولة استقبال صديقاتي بأريحية، والتجول المفتوح، نلتقي عند نقطة، ثم ننطلع ونجوبها طولاً وعرضًا، والأمر الذي يستدعي التأمل هو كيف أني أعرف اسطنبول وأزقتها ودكاكينها، وشوارعها -رغم أني لم أسكنها إلا منذ سنتين تقريبًا – أكثر بكثير مما أعرف جدة، المدينة التي سكنتها 30 عامًا ! أظن لو تسألوا بحر مرمرة عني لنطق وأجاب، لكثرة ما كان رفيق أيامي .. لنعد لصديقاتي، ممتنة كل الإمتنان لدلال، وأسماء، ونوال، فقد عبروا بالمدينة، لكنهم أقاموا في قلبي أبدًا ..
عن الحب ..
ربما سيكون هذا الجزء الأصعب الذي سأكتبه خلال هذه التدوينة، فنحن نحلم طوال حياتنا بأن نحب، وأن نكون محبوبين، ولطالما عشت في أمل البلوغ للحظة حب عظيمة، وأحسب أني عشتها، وسأظل ممتنة لها طوال حياتي، إنها تلك اللحظة التي تحس خلالها أن الحياة للمرة الأولى تهديك المعنى منها واضحًا جليّا، ثم حين تضطر إلا الرحيل عنها، تشعرك بأن حياتك من بعدها فراغ هائل، لا تعود الدنيا هي الدنيا، تشعر بالبرد لأنك تعرف الآن يقينا أنك عشت طوال حياتك وحيدًا ، بينما الآن فقط ستمشيها وحدك. وها أنا أمشي هذه الأيام وحدي بعدما عرفت تجليات الأنس، والسعادة الفريدة. وأقول سعادة فريدة لأنها كذلك فعلاً، ربما ستصادف السعادة في وقت آخر لاحقًا، لكنها لن تكون بذات الشبه، ولا بذات العمق، ولا بذات التفاصيل، ستستقبلها، وأنت تعرف أن دمك أصبح مطعمًا بحزن نبيل، ذاك النوع من الحزن الذي تود للأبد أن يلازمك، لأنه القطعة الأخيرة من حبك العظيم .. أنه ألم الرحيل والفراق بعد الوصل والذهول .. لأنك ستكون قد عرفت للمرة الأولى أنه لن يعوضك شيء بعد الآن .. وسترضى أن تبقي على هذا الألم كوجود نهائي لأصل ذاك الحب.. وتحفظ الذكريات كأثمن شيء يملكه وجدانك .. وتمضي حاملاً هذه الزوادة في أيامك القادمة .. وسيبقى الحب وإن انتهى الدرب ..
أمنيات تحقق نفسها في غير وقتها ..
كنت أجمع في دواخلي أمنيات كثيرة، بعضها نسيتها ، وبعضها اختلفت في عيني، وبعضها ظلت لها قدسيتها لأنها إن حدثت فستكون لحظة تحول لي في حياتي، وهي كذلك حقًا، لكنها حدثت في أشد أوقاتي حرجًا على صعيدي النفسي، ففقد كان لدّي اكتفاء من الحياة، ولست في مزاج يجعلني أعيش تفاصيل الأمنيات كما تخيلتها طوال حياتي، حققتها لأنها الفرصة التي لا أعرف متى ستعود وتتكرر، ولأني لم أنسى أنها كانت ضمن قائمة طويلة لم أعد اكترث لها بقدر ماكنت أفعل سابقًا، لكن لأجل أن تكون سويًا ومنصفًا لنفسك، ستحاول، وتجرب، و تصدق أنك فعلتها حتى دون تخطيط مسبق .. ستأخذها على احتمال أن الحياة لازالت تملك الرحابة والقدرة على إدهاشك من جديد، فتحاول بهذا الاحتمال أن تلتقط ماتحاول الأيام أن تضعه في طريقك علّها تكون مكافأة لك على صعوبات الحياة التي احتملتها طوالك عمرك .. أتذكر جيدًا، كيف دفعت تذاكر حفل ديفيد قارت دون أن أفكر مرتين، وأتذكر كيف اشتريت أول تذكرة لسفري وحدي، وأتذكر المرة الأولى التي انطلقت فيها وأنا أمسك بمقود السيارة، والمرة الأولى التي سكنت فيها ليومين في بيت أحدى صديقاتي، وأعرف جيدًا اليوم معنى أن يهاجر الإنسان أماكنه، وما أعتاد عليه، ومايحبه ومن يحبهم لأجل أن يجد نفسه أو يقترب منها ويفهمها على الأقل.. ويالها من حكاية طويلة هنا ..
مبسوطة؟
صار صعبًا علي أن أجيب على سؤال بسيط كهذا، فغالبًا يعتقد الناس بأن تجربة الانتقال لبلد جديد للعيش فيه والاستقرار هي تجربة تنقلك من الشقاء للسعادة، والحقيقة أن الأمر مختلف كلية، فأنت إذ تنفصل عن مكان مولدك ونشأتك لتبني حياتك من جديد ليس أمراً سهلاً بطبيعة الحال . لكن هناك جواب أحب أن أقوله وهو أني في هذه الفترة أحاول التأقلم، والارتياح، علّي أواصل “حلمًا ما” تراكمت عليه الأيام وتلاشى، فلدي مساحة أرحب لأبصر ما أريده، وأمضي بشكل واضح في الاهتمام بصحتي، ونفسيتي، وسلامة عقلي وجسدي .. ولأكون صادقة كل الصدق، فهذه المرحلة مرحلة العناية بقلبي .. مرحلة أن أكون كل شيء لنفسي في وحدتي.